عُدتُ والعودُ «عَلِي»
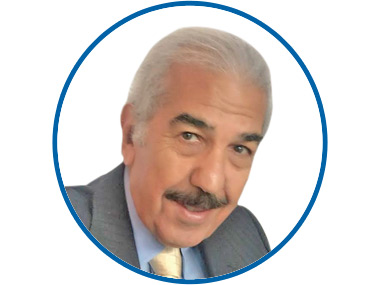
تعطل هذا القلم وصمت بعدما ألقيت عصا الترحال في عالم الكتابة، ودّعت الكتابة وألحدتُ القلم وهلتُ عليه ذكريات وشجونها.
أربع من السنوات أعلنت خلالها الحداد وعطّلت ملكة الكلام وبتّ أرعى نجمات الليل، هل حملت مما كتبت حرفا؟! وهل زهت بتلك الكتابة الممهورة بخاتم النسيان؟
وظننتُ أني لستُ بعائدٍ إلى قلم مات وحبرٍ جفّ أديمه، حتى كان اليوم الثامن من شهرنا هذا حين نعى الناعي «علي محمد البداح»، فإذا بذلك القلم المطمور المقبور ينتصب واقفا ويسلم نفسه ويقول «هيت لك»!! وإذا بذلك الحبر اليابس الجاف أديمه، سلسبيل يتدفق يتعطش لقلم كان يرتوي منه ولا يبتل صاديه.
أرثي «علي البداح»
فهل أرثي «ابنَ خالةٍ» أم أخاً أم أباً سنوات عمره تحاذي سنواتي، ولكن سنواته أنضج، وبذلك تربّع في قلبي منزلة الأب.
بكيت وأنا الداني من الثمانين ابن خالة سبقني إلى الدنيا بسنوات ولكن حضوره الطاغي ورجولته المبكرة وثقافته المشعة منذ صغره أدنتني منه وجعلته بمنزلة الأب.
كانت «حولّي» الخمسينية البريئة الطاهرة حاضنتنا ومدرستنا التي تلقيت فيها دروسي الأولى على يده،
علمني دون قرطاس ولا قلم.
نصّبتُه معلّما أغرف منه دون أن يدري وأستلهم منه وأستزيد، هل أقول إنه معلمي الأول؟ نعم هو كذلك بل أزعم أنه معلّمٌ لكل من عرفه.
كان معلّما في السموّ وفي الحب الرفيع، ولم يكن معلم حروف وجُمَلٍ ودروس مسطورة على اللوح بلا روح... عاش طفلا حكيما لم تجذبه الساحات الترابية يصارع أترابه على ألعابها، كأنما هو ناسك بلا معبد ومصلٍّ بلا قبلة.
كثير يقال عن «علي البداح» وليس أهمّه بره بأبيه ووفاؤه له بعد غياب أبيه الغامض منذ أكثر من ستين عاما، في جريمة عرفتها الكويت في فجر استقلالها عام ألف وتسعمئة وواحد وستين، حين غاب مراقب البلدية في حولي «محمد علي البداح» منذ ديسمبر ذلك العام حتى يومنا هذا وما زال مصيره غامضا ومجهولا، فلا أحد يعرف أين مضى ولا من كان وراء تغييبه!!
الابن «علي» لم ينس والده وظل يبحث ويطرق الأبواب المغلقة ويقتحم أهوالا تعرضه للخطر من أجل محاولته معرفة مصير والده، حتى مات وهو مازال يحمل تلك القضية، وكثير من كتاباته تروي تلك المعاناة.
رحمك الله يا ابن الخالة يا أخي الأكبر... بل يا والدي.
اليوم أحسّ باليُتم.
إلى أمان الموت يا «علي»... حيث هو الأمان الأكيد.


