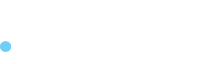عبدالإله بلقزيز في رائحة المكان... رحلة إلى حيث حدائق المعاني المقدّسة
قد يكون المكان قادراً على الإقامة في أهله أكثر ممّا همّ قادرون على الإقامة فيه. وحين يغادر الإنسان مكانه يظنّ أنه ذاهب إلى مكان آخر، ويكتشف بعد حين أنّ الأمكنة تحترف الذهاب أيضاً، فنقيم في المكان الجديد نحن والمكان القديم. هكذا، نتحوّل بعدما تكثر أمكنتنا إلى مكان للأمكنة. وقليلة هي المطارح التي نعبرها ولا تعبرنا، نستوطنها ولا تستوطننا. في جديده «رائحة المكان» يؤدّي الأديب عبد الإله بلقزيز نصًّا، كما هو مثبت على الغلاف. وكأنّه بكلمة «نصّ» يهرب من التسمية، فكلمة «نثر» قد لا تكون مرضية، وكلمة «شعر» قد لا تكون مناسبة. غير أنّ متصفّح النصوص يكتشف سريعًا أنّه يقرأ نثرًا، وقد تضمّن الكتاب بضع قصائد تلفت النظر قبل قراءتها بسبب الإخراج والتوزيع الطباعيّ. وسؤال تطرحه المناسبة: «إذا كانت هذه النصوص ليست نثرًا فما هو النثر الفنيّ إذًا؟ والإجابة بكل بساطة، النثر الفنيّ يقيم في هذه النصوص، لكنّ أهل الكتابة الفنيّة عندنا، بسوادهم الأعظم، يتحاشون تسمية «النثر» كأنّه بنتٌ بالمفهوم الشرقيّ والقصيدة صبيّ.
يستهل بلقزيز كتابه بنصّ إلى محمود درويش حضرت فيه القوافي وغاب عنه الوزن السليم: «ما دلّني أحدٌ عليّ سواك / يا ابن حوريّة تحنّ / إلى خبزها وقهوتها/ ومن دمعتها إن متّ تئنّ... بهذا الكلام يكشف صاحب النصّ عن أن درويش بوصلته إلى ذاته وربّما إلى نصّه أيضًا الذي يدخل في أكثر من موقع دائرة الظلال الدرويشيّة. عميقًا في بئر الزاويا يرسل صاحب «رائحة المكان» يده، فترفّ ملء عينيه أسراب المعاني، ويصطاد برأس قلمه المروّس وجعًا تلو وجع، و{يضيّف» قارئه فاكهة متنوّعة تختلف طعمًا واللذّة قاسم مشترك بينها وقد استعاض عن العناوين بالأرقام، واكتفى بعنونة الأبواب تاركًا للقارئ أن يرتئي بالعنوان المناسب بعد كلّ نصّ قصير. ففي «باب البيان» يعلن بلقزيز فرحه بالانتماء الى أمّته التي لسعها الشّعر، وكان له هويّة: «البيان هويّة العربيّ منذ قذفت به السّماء في الصحراء». ومن مثل العربيّ يجتاز الفيافي ليصطاد بيتًا من الشّعر، ومن مثلُه يدلّه دمه المشتعل على السيف والجريمة وهو في الوقت نفسه: «أمام جملتين مطرّزتين بسجع ينحني ويبكي»؟! وربّما لقناعة المؤلّف بأنّ العرب يؤخذون بالسجع راح يسجّع من أوّل الكتاب إلى آخره، ولقد أرهق السجع الكلام وجعل أوّل الجمل موفّقًا أكثر من آخرها المحكوم بقافية النثر عند العرب إذا جاز الكلام: «والبيان ما أذهل، ما أزاح الحجاب وفكّ المقفل، البيان ما أجمل»... ولو لم يقع الكاتب أسير السجع لقاده الكلام إلى ما يطيب من المعاني أكثر، ولشعر القارئ بأنّه حرّ في آخر الجملة إذ لا قيد ينتظره. يعرف بلقزيز كيف يؤوي التاريخ في الأدب ليرضي وجدانه بعيدًا من رتابة السّرد وبرودة الخبر: «ونصر القبيلة على رأس رمح لسانها محمول... كم من نصر أضاعه بيتان من قصيدة، وأردياه محسورًا، وكم من سجع خرافيّ بنى على صحوة الحصان عرشًا مهجورًا»... ومن الملاحظ أن الكلام على البيان واللغة والكلام والشعر... يثير محبرة المؤلّف فيتوّجها شهيّ الزّبد. يقول: «يكفيك أن تكتب قصيدة حتى تنقذ لحظة إنسانيّة حارّة من الضياع في زحمة اليوميّ». نعم، الشعر، ووحده الشعر، يقبض على الزمن، ويؤبّد اللحظة العابرة في صدر الكلمة، في أجمل السجون وأشهاها على الإطلاق. لكنّ صاحب الكلام يسمح بتقديم التنازلات: «على المعنى العميق ألا يضيع منك لمجرّد أنّك لم تعدّله زفافًا لغويًّا يليق به». وهذا الكلام يحمل الأخذ والرّد لأنّه يفسح في المجال للمعنى على حساب اللفظ، فعلى الأقلّ يجب العدل بين اللفظ والمعنى. وإلا فأين فضل الشّعر، وأين بيانه وسحره؟ ورحم الله الجاحظ رائيًا المعاني مرميّة ومطروحة في الطرقات. وليس بلقزيز غريبًا، وبعيدًا عن هذه الحقيقة وهو القائل: «لكنّ الأشياء لا تسقط بيسر في حبائل الألفاظ، ولا تقدّم نفسها لمن يسمّيها». لا شكّ في أنّ من كتب متوّجًا برائحة أمكنته صاحب قدرة على شحن الكلمات بطاقات تعبيريّة وإيحائيّة رائعة، غير أنّ الإطالة تقف ضدّه والاختصار يقيه المرور بالعاديّ أو بالمفسّر فكم هو موفّق حين يقول: «انتعل خطوَك»، أو «ما المستحيل... إلا قمرٌ طروب تتحرّش به النظرات من الشرفة»، أو «رابط بين مفردتين... تعلّقان الأشياء على صليب الاستفهام»، أو «أكتب كي تهزم الماضي أو تعقد صلحًا معه»... ولا يفوت بلقزيز النقد، وإظهار تعاسة الشرق الأدبيّة: «الشعراء أكثر عددًا من القصائد، وهو العارف من أين تؤكل كتف الكلام شعرًا، الشامّ القصيدة قبل أن تمسحها عيناه والمحاول تعريفها بأنّها المنقذ في النثر اليوميّ وبأنّها: «رحيق الرّوح يسكب شهده على مساءات تلقي التحيّة على بوّابة صدرك». وقد رمى قصيدة العرب المدحيّة بأقسى الصفات إذ هي إناء الكلمات الباردة: «لا ماء في وجهها وهواؤها ملوّث بالدينار، إيقاعها كرباج، وقافيتها أصفاد، والعنوان جيفة». وفي هذا السياق أيضًا وجّه سهامه الى القصيدة المنبريّة معتبرًا تصفيق الجمهور لها مقتلاً: «يقتل القصيدة خطابها الخارجي وصوت جمهورها المرتفع»... ولم ينج منه شعارير العصر الذي يتكاثرون كالبعوض على صفحات الجرائد والمنابر... وبين جولة نثريّة طويلة وأخرى يستيقظ الشاعر في صدر بلقزيز وتكون القصيدة الحديثة بحسب ما يوحي الإخراج الطباعي: «ما قلت الذي أقول / كي يصلبوني على ألواح / اللغة / أو يكشفوا عورتي / في الأقبية». ولو أتى إخراج هذا الكلام كإخراج النثر لما كان هناك من فارق بينهما لا سيّما أن نثر بلقزيز في أكثر من موضع مثقل بالإيحاء وموشوم بفنيّة عالية. هروبللسياسة حضورها في صندوق الذكريات حين يفتحه بلقزيز بألم وهو محاصر بالمكان: «ما ألذّ الهروب من مكان تضيق به وبك يضيق كي ينبعث المعنى فيك من جديد». والمعنى عند الكاتب لا يخلو من السياسيّ: «إرحل، ولا تأخذ شيئًا ممّا كان لك غير قصيدة كتبتها أمس، وقلادة عليها رسم مطرقة ومنجل». والرحيل هو بمعنى الهروب إلى أيّ مكان آخر يختلف بما فيه وبمن فيه وبمعانيه أيضًا: «شمعتان ونهدان يتوّجان الليل خارج الحيّ». إنّها المرأة التي يلاذ بها بعد زمن الخيبات والهزائم، فنهدٌ هو مطرقة ذات إيقاع جديد يملأ القلب، وثانٍ هو منجل يحصد سنابل اللذّة في حقول الروح التي تنتظر حصّادًا تأخّر في المجيء... وقد استرسل بلقزيز في سرد حكايته مع السياسة التي أتت على حساب الأدب واعترف بأنّه طلّقها: «فقد فات الذي فات... وما عاد القلم طيّعًا لمديح الأوتان. باسم من تكتب إذن، بعد انقلاب الميزان؟» وإذا كان الكاتب الذي نذر عمره للثورة، ترك وظيفته كناطق باسم الجماعة إلا أنّه بقي بصحبة محبرته، لأنّه بدأ يكتشف لنفسه ولألمه: «أكتب باسمك ولا تكتب بلسان الجماعة». وتنازل عن رغبته في أن يكون النبيّ والوليّ والبطل: «أنت عاديٌّ تمامًا كحزن أهل الحيّ في المآتم». تحضر المرأة في «رائحة المكان» في فصل خاصّ بعنوان «بابها». فهي أوّل رحلة الوجود: «وحدها في البريّة تبحث عمّن يشبهها فلا تجد». وكلّ ما في الطبيعة يدور في مناخ همّها قمرًا وماء وريحًا وطيرًا، و: «صورة وجهها على صفحة ماء البحيرة والأبد». المرأة عند بلقزيز خيمة الروح وسبب وجود القصيدة... يحتضن «رائحة المكان» معاني وجوديّة قدّمها عبد الإله بلقزيز إلى قارئه على بساط تجربة حياتية، بعدما ألبسها حلّة أدبيّة لائقة ليمنحها بنعمة الجمال حياة أطول والجمال على كل شيء قدير.